تقرير: أسامة حراكي
في الطائرة كنت أفرغ خيالي من أي تصورات مسبقة لأواجه المدينة كما هي، وليس كما كنت قد صنعتها في خيالي، مدينة كانت حاضرة العالم ويقصدها كل من يطلب العلم، مدينة الكتاب والشعراء والمطربين الذين ملأوا ذاكرتي بالجمال وبالنصوص والقصائد والأغاني التي لن تنسى، وليس أيضاً كما يصورها الإعلام، بهذه المخيلة الفارغة المهيئة لمشاهدة الغرائب في بغداد عاصمة الإعلام العربي لعام 2017 ـ 2018 لكني كنت متيقناً من أنها ستكون ممتعة بالرغم من كل ما يقال إلى أن وصلنا مطارها.
في المطار كان المفترض تسهيل مأمورية عبورنا وإعفاؤنا من متاعب الإنتظار، وكلما كنا نطلب من الضباط الإسراع في الإجراءات يُطلب منا الإنتظار، بينما كانوا يسمحون لجنسيات أخرى العبور بسلاسة، وراحوا يطرحون علينا الأسئلة لماذا حضرتم وكم من الأيام سوف تُمضون في العراق، وأجبناهم أننا قدمنا بموجب دعوة رسمية أطلعناهم عليها، وأن في الخارج هناك مندوب ينتظر وصولنا لاستقبالنا، ثم سلمونا جوازاتنا متماطلون كما لو أنهم يسمحون لنا بالعبور على مضض.

انطلقت بنا السيارة التي ستقلنا إلى الفندق، لتلتقط عيني وجود كثير من الجنود و”السيطرة” وهي الحواجز الأمنية كما يسمونها أشقائنا العراقيون في الطرق، وأبنية وعمارات قصيرة، لا يحتاج الشخص إلى كثير من التأمل ليعرف أنها كانت جميلة ومن طراز رفيع، إلا أن الحروب المتتالية تركتها جمالأ منهاراً أو باقياً فيه بعض الرمق، وحين نويت أن ألتقط لها بعض الصور من خلف زجاج السيارة، أشار لي أحد الجنود بيده أن لا، وعليا أن أعرف الأماكن التي يسمح لي بالتقاط الصور منها وما هي ممنوعة، خصوصاً أن مشهد الحرس والجنود منتشرين في كل مكان ونحن نسير في الشوارع.
وفي يوم الخميس 29 مارس، انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2018 تحت شعار “نقرأ لنرتقي” بمشاركة أكثر من 600 دار نشر عربية وأجنبية، وبالنيابة عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، افتتح المعرض نائبه مهدي العلاق.
وكانت هذه الدورة هي الأكبر من حيث المشاركة منذ تأسيس المعرض قبل أربعة عقود، وقُدم في هذا الإطار برنامجاً ثقافياً متنوعاً تضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية، وحفلات توقيع لأحدث الكتب.
وإلى جانب المشاركة الكبيرة من المثقفين العراقيين، استضاف المعرض مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء من دول مختلفة، على رأسهم الروائي الجزائري “واسيني الأعرج”، وكانت دولة الكويت هي ضيف شرف هذه الدورة.

كنت طواق لاستماع الكثير من الأغاني العراقية التي في ذاكرتي منذ سنوات طويلة، ظننت أن بغداد سوف ترحب بي بأصوات مطربي العراقيين المفضلين “كاظم الساهر”و”سعدون جابر” والرائع “ناظم الغزالي” وخصوصاً العمل الخالد “أي شيء في العيد أهديكِ” كلمات ايليا أبو ماضي المرتحل من لبنان لمصر لنيويورك في أمريكا حيث وافته المنية.. عن الحب كانت القصيدة ثم الأغنية أم عن الوطن؟ أم أن المعني في قلب الشاعر تماماً كقارئه الفنجان.
إلا أنني تذكرت أن موجات الحداثة والصخب والسرعة تطال الأماكن القريبة والبعيدة، القديمة منها وحديثة التأسيس، هذا ما كانت تقوله الأغنية الصاخبة التي كان يستمع إليها السائق في اليوم الأول لتجولي ببغداد، وزملاؤه الأخرون في الأيام التالية.
في اليوم التالي خرجت أسير بأقدامي على نهر دجلة، على جانبه كان النخيل والشمس، وعلى الجانب الآخر كانت شوارع وأبنية تتداخل في بعضها ببساطة مريحة رغم مسحة الدمار والإهمال عليها، كانت تعلن أنها تتعلق بزمن جميل، على درجات النهر هناك رحلات بالقوارب يركبها الناس يتلمسون دجلة بأصابعهم ويمتعون أعينهم بشاطئه الجميل، تتأرجح بهم القوارب على سطح الماء النابض بالحب والحياة.

تابعت المسير على حافة النهر حتى وصلت لحدائق دجلة، وفجأة ظهرت أمامي! الجميلة التي تشتهي لو تعود بها الحكاية إلى جديد الليالي، بعد أن ملت الهجرة خارج الحكايات معلقة بفراغ الغياب، تبحث عن حكاية جديدة تعيش على وقعها، ووجود متفرد لجوهرها الأنثوي الاستثنائي، تبحث في عيون حفيداتهاعن بداية جديدة للخلاص من صمتها الذي طال، تبحث عن الدهشة في روح أهل هذا الزمان، وهي التي تعرف أن وجوداً بلا دهشة هو هوة وسقوط في الفراغ، إنها شهرزاد التي ملأت الدنيا حكايات أثرت ذاكرتنا ووجداننا بقصص عالم عجائبي، تفردت وحدها دون نساء الأرض بابتكاره، عن التاريخ القديم وأخبار الملوك والسلاطين، والجن والإنس من لصوص وشُطار وحكماء وأبطال وحيوانات، كانت واقفة تقص حكاياتها على الملك شهريار الذي يجلس مسترخياً يصغي لقصصها، التمثالان في هذا النصب من تصميم النحات “محمد غني حكمت” كانت واقفة شامخة في قلب حدائق دجلة على ضفافه، فسألتها: هل رويتي لنا كل الحكايات يا شهرزاد؟ فقالت: وهل رويتم أنتم كتاب هذا الزمان كل ما حصل لبغداد! أم أنكم تنامون كل ليلة بغصة الكلمات؟
ثم وصلت شارع أبو نواس شارع الشعراء والعشاق كما كان يسمى، وهو من شوارع بغداد الجميلة، يحرسه تمثال “الحسن بن هانىء الحكمي” الملقب بأبو نواس، شاعر الخمر الذي ترك ما كان فيه واتجه إلى الزهد وكتب العديد من الأشعار التي تدل على ذلك، التمثال يحرس الشارع ومن بعيد لمحته يرنو، بيده كأسه الشهير الطافح شبقاً وعشقاً، الناهل من كل متع الحياة على اختلافها.. التمثال أبدع في تصميمه الفنان “إسماعيل فتاح الترك”.

الأشجار الكثيفة تحتوي الشارع من الجانبين، وسلسلة المقاهي والمطاعم الشعبية التي فيه، وروائح الكباب العراقي بأنواعه الذي يقدم ساخناً مع خبز التنور، ورائحة السمك المسكوف “المسقوف” باللهجة العراقية، وهو سمك مشوي يشك في عيدان الخشب وفي وسطه يوضع الحطب ليشوى على نار الحطب الهادئة، وأفضل الأسماك النهرية ببغداد “الشبوط ـ الكطان ـ البني” الذي يتم صيده مباشرة ويوضع في أحواض ماء ليبقى حي ويستخرج طازج عند الطلب.
وصلت شارع “الكرادة” وجلست في مقهى “أرخيته” وشربت استكانات “كؤوس الشاي المعطر بالهيل” الشاي العراقي الداكن الذي يقدم بكثير من السكر في فنجان صغير، والذي لم أرى حاجةً أبداً لخلط تلك الكمية الكبيرة من السكر مع تلك الكمية القليلة من الشاي، خلافاً لما اعتدت عليه من الشاي الأحمر الفاتح في كوب بلا سكر، المقهى مكون من كراسي وضعت على الرصيف يجلس عليها كثير من الرجال في كتل صغيرة، منهم من يشرب الشاي، ومنهم من يشربون “الغرشة” كما هو دارج في اللهجة العراقية “الأرجيلة ـ الشيشة”، هذا المقهى الذي كان يجتمع فيه كثير من نساء ورجال أدباء العراق، ومن أشهرهم الشاعر محمد مهدي الجواهري الملقب بالنهر الثالث، وعلمت أنه استُهدف من قبل وتم تفجيره، ما أدى إلى كثير من القتلى والجرحى.

بدأت حفاوة الأصدقاء والتي تكررت ليصنعوا لي أجمل أيامي البغدادية القصيرة في العراق، وقابلت الصديق والرفيق فاروق، حيث جلسنا جلسة طويلة معاً استعدنا فيها ذكرياتنا في جنوب افريقيا، وتناقشنا بعدة موضوعات.
وفي صباح اليوم التالي انطلقت برفقة الصديقين العراقيين رياض وفجر باتجاه المتحف البغدادي الذي زرناه، ويضم أعمال ومجسمات تستعرض وتحكي التراث الشعبي العراقي، ثم اصطحباني لزيارة شارع المتنبي الذي يكتظ بالكتب التي تمطر من المحلات والأرصفة والأبسطة البسيطة على جانبي الشارع، وكأنه كرنفال كتب وقراء، ولا تنقطع التحايا التي سمعناها بين ثوان وأخرى يتبادلها الناس الذين أصبح لهم شارع المتنبي نادياً يلتقون فيه كل اسبوع، ويتبادلون الأحاديث المقتضبة بينهم، الشارع تتخلله بعض الأبنية القديمة الرائعة باللون البني الترابي، وفي نهايته فاجئني دجلة ثانيةً بجماله وعلى ضفافه تمثال لأبي الطيب المتنبي.

كنت أشعر اني في فيلم جميل يحدث في بغداد رغم ظلال الموت والقلق والخوف المخيمة عليها، والألم الذي أسمع صوته من أجساد البيوت والأزقة القديمة والشبابيك الخشبية الجميلة التي أهملت وتآكلت في خضم الآلام والجروح، كنت أرى النظرات المفعمة بالشجن في عيون العراقيين الذين هم من أصدق وألطف الناس، الذين يتمونون أن يفتحون شبابيك الضوء والأمل وسط الظلام والحزن، ينتظرون يوماً لا يشاهدون هذا الدمار والخراب في الشوارع.

في شوراع بغداد لاحظت فارق طبقي في المجتمع، حيث الكثير من السيارات الفارهة باهظت الثمن، بجانب السيارات المتوسطة والمعدمة، والبضائع الرخيصة التركية والإيرانية والصينية، في شوارع كانت مثالاً للبذخ والسعادة بالنسبة لهم.
في أخر يوم ونحن في طريقنا إلى المطار لنغادر بغداد، تذكرت سندباد وعصفورته ياسمينة وصديقه علاء الدين، الشخصيات الكرتونية الذين أحببناهم في طفولتنا وتابعناهم وكنا نتمنى أن نساعدهم للعودة إلى بغداد، فقد شاركناهم حلم العودة إلى موطنهم ذات مرحلة بيضاء من العمر، لكن هل من مصلحتهم الآن أن يعرفوا الطريق الصحيح لبغداد؟ وإن وصلوا إليها الآن فماذا سيجدوا؟ وما سيرون ويسمعون؟ ماذا تبقى من بغداد؟ لا أعلم لماذا شعرت بالمرارة في زيارتي لبغداد! كنت أود أن أصرخ وأقول: سندباد نحن أصدقائك القدامى، نحن الصغار الذين كنا نستقبلك عبر شاشات التلفاز بفرح، نحن الذين كنا نحفظ أغنيتك أكثر من دروسنا المدرسية، نحن الذين كنا نردد معك بإصرار مهما تكثر الأخطار ويبعد عن بغداد، كنا نتمنى لو ان الزمان وقف بنا أمامك ولم نغادرك ولم نكبر، والحياة لم تسلبنا براءة قلوبنا، وبقيت أحلامنا خضراء وقلوبنا بيضاء نقية.. اعذرنا فالأخطار كثرت جداً في بغداد وابتعدنا عنها، ففي يوم 9 ابريل 2003 سقطت بغداد ودخلتها جيوش الامبريالية ومن يومها لم تعد كما كانت، فعلى مدار الزمن التاريخ يوزع الأوسمة والألقاب على قادة الشعوب، فإذا أردنا أن نعرف اللقب المناسب لأي قائد فالننظر إلى حال شعبه.



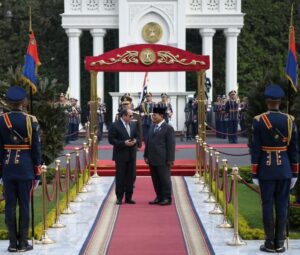



المزيد من الموضوعات
أسامة حراكي يكتب: التراث
وزارة الثقافة تحتفي بمبدعي ومثقفي مصر في إحتفالية “يوم الثقافة ” 8 يناير القادم…
عمر الشريف يكتب: فلا يؤذين